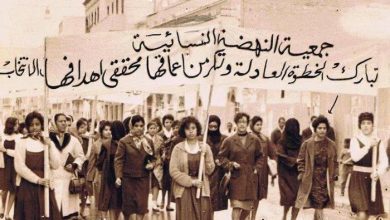وفي العصر البطلمي استمدتْ اسمها الثاني «بيرنيكي» من أميرة قورينا الجميلة بيرنيكي، عقب زواج بطليموس الثالث من أميرة البلاد في ذلك الوقت «بيرنيكي» ابنة ماجاس حاكم «كيرينايكي»، ووريثة عرشه، في عام 246 ق.م، أشار لها الجغرافي بطليموس في القرن الثاني الميلادي باسم بيرنيكي، وأشار الجغرافي سولينوس الذي عاش في القرن الثالث الميلادي إلى أن الملكة بيرنيكي قد منحت اسمها لهذه المدينة التي أحبتها وقامت بتحصينها، ولعبت في أحداث المنطقة التاريخية دورًا بارزًا، واعتبارًا من عام 96 ق.م أصبحتْ تابعة للحكم الروماني، وبنيت بالمدينة الكثير من المنشآت كما زينت أرضيات تلك المباني بفسيفساء رائعة أشهرها فسيفساء الفصول الأربعة وقد تم الاهتمام بالمدينة في أوائل العصر البيزنطي «القرن الرابع الميلادي».
وأصبحت تعرف باسم «برنيق» في الفترة الإسلامية، وكان تاريخ بنغازي مع الإسلام قد بدأ اعتباراً من العام 642م، حين قاد عمرو بن العاص جيوش الفتح الإسلامي إلى ليبيا متخذًا من مدينة برقة «باركي» لتكون مقرًا وهي مدينة المرج الآن، في الإقليم الذي كان يسمى قورينائية «كيرينايكي» نسبة إلى مدينة «قوريني»، ويتقاطع تاريخ تلك المدينة وتختفي الكثير من أحداثه عبر سنوات طويلة مجهولة، إلى أن يسجل أنه عقب الفتح الإسلامي بنحو أربعمائة عام تشهد المدينة هجرات «بني هلال»، و«بني سليم»، وتعرضها لما وصف بالاضمحلال، ثم تضيع أربعمائة سنة أخرى من الوقائع التاريخية للمدينة.
في أواسط القرن الخامس ميلادي عاودت المدينة الظهور وازدهرت من جديد، وتم استبدال اسمها باسم مرسى بني غازي الذي ظهر إلى حيز الوجود لأول مره عام 1579م وظهر الاسم على خارطة قديمة رسمها علي بن أحمد بن محمد الشريف جغرافي تونسي من مدينة صفاقس.
وتعود تسمية المدينة للولي الصالح سيدي غازي بن محمد بن غازي بن غانية الصنهاجي البرانسي المرابط، الذي سميت عليه مدينة بنغازي والقادم من مدينة فاس بالمغرب، حيث وصل للمنطقة في 1510م واستقر بها حتى مرضه ووفاته، عاش بقية أيام حياته في المدينة التي حملت اسمه ودفن فيها، ويوجد ضريحه فوق ربوه داخل مقبرة سيدي خريبيش، بجانب المنارة التي تتوسط هذه المقبرة، أصوله تعود إلى قبائل صنهاجة في المغرب التي تنحدر بدورها من البرانس، أما مرابط فهي صفة لدولة المرابطين التي وضع اسسها عبد الله بن ياسين بن مكوك بن سير بن علي الگزولي الصنهاجي 1056 1142م، وتكونت هذه الدولة من قبائل صنهاجة في الأساس مثل لمتونه وقداله وكزوله وغيرها، وكان هذا قبل محاولة دخول بني هلال وسليم للقيروان سنة 1057م.
وقبل أن تشتهر المدينة باسم مرسى سيدي غازي، كانت تعرف بـ «إكوية الملح»أي قرية الملح، واطلق هذا الاسم من قبل سكانها في حدود سنة 1500م، حيث يعد تجارة وتصدير الملح العامل الرئيس الذي قامت المدينة أصلاً عليها، نتيجة لوجود سبع بحيرات من المياه المالحة في وسط المدينة وبالتالي كانت أكبر مصدر للملح في المنطقة، وكانت سببًا في وجودها واجتذاب السفن التجارية إليها واستقرار عدد من الجاليات التي تمتهن التجارة بها، حيث كان التصدير لتركيا واليونان، وإيطاليا، ومالطا، والبانيا، وغيرها من دول البحر الأبيض المتوسط ، وقد استمرت هذه التجارة قوية ورائجة وذات دخل كبير طوال العهد العثماني الأول، واستمر رواجها حتى النصف الأول من القرن العشرين.
استمرت المدينة محتفظة بمكانتها إبان فترة الحكم العثماني عندما اختيرت كمركز إداري، وتم تعزيز هذا الدور من خلال تحويلها إلى مركز عسكري رئيس خلال فترة الاحتلال الايطالي، وقد تعرضت المدينة خلال الحرب العالمية الثانية إلى دمار كبير، تغير مظهر المدينة بشكل طفيف إبان فترة الادارة البريطانية، وبعد استقلال البلاد في العام 1951م استعادت المدينة أبعادها التي كانت تمتلكها قبل الحرب.
ويتمثل الموروث الحضاري للمدينة موقع هيسبريديس وبيرنيكي، والمدينة التاريخية، والمقابر القديمة، والمباني التاريخية القديمة والزوايا الدينية، وتعد العاصمة الثقافية في ليبيا لكثرة الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية بها، فهي مقر أول جامعة ليبية، كما يوجد بها المسارحد ودور السينما والمراكز الثقافيةد ودار الكتب الوطنية.
مدينة «البحيرات السبع»، هذا الاسم نسبة لسبع بحيرات بالمدينة، وتعرف هذه البحيرات على أنها مناطق طبيعية مغمورة بالمياه العذبة، أو ذات ملوحة عالية، أو منخفضة، التي إما أن تكون جارية أو راكدة، وتعد بمظاهرها الطبيعية والايكولوجية العنصر المنظم للحياة البحرية والحياة البرية والتنوع الاحيائي، كما تعد أيضا ذات قيمة اقتصادية، إذ بإمكانها أن تشكل امكانية مهمة للدراسات العلمية المستفيضة والسياحة الطبيعية والانشطة الترفيهية.