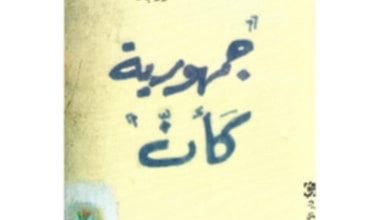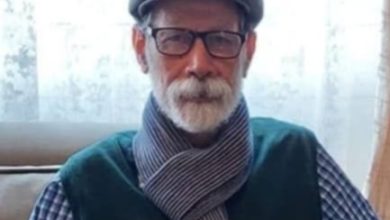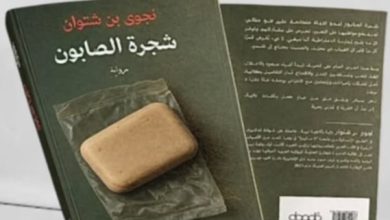كتب حسين أحمد أمين كتابه )دليل المسلم الحزين( مطلع الثمانينيات، وفي تقديمه للطبعة العاشرة سنة 2006، يشير إلى أن مقالات الكتاب لا تزال صالحة حتى الآن، ولم يُعدَّل فيها شيء؛ بل إن الأوضاع أصبحتْ أكثر سوءًا، وأن المسلم يعيش في أضيق العصور، خاصة بعد تزايد ظاهرة الإرهاب..أعادت دار )العين( نشر الكتاب مؤخرًا بعد أربعة عقود من صدوره الأول؛ فهل يمكن أن يساعدنا في تحليل تراثنا وفهم واقعنا المعاصر؟
من لوثر إلى عبده: لماذا فشلنا في اللحاق بالقطار؟
ظهر الإصلاح الديني مطلع القرن السادس عشر على يد الراهب «مارتن لوثر»؛ فقد كانت الكنيسة قد وصلت إلى مرحلة مزرية، توجت آنذاك بصكوك الغفران.
تتلخص رؤية «لوثر» للدين في أنه خلاص فردي، أي أنه من حق كل شخص أن يقرأ الدين ويفهمه لوحده بدون الحاجة إلى وسيط. أزعجت رؤية لوثر السلطة الدينية وحكم عليه بالهرطقة، ولكن بمساعدة فريدريك الحكيم، حاكم ساكسونيا، استطاع النجاة وقدّم إلى شعبه الألماني أول ترجمة للكتاب المقدس، فبات عامة الشعب قادرين على قراءته وفهمه. أدى هذا الإصلاح فيما بعد إلى ظهور عصر التنوير، وهي الانطلاقة الفعلية لنهضة الغرب.
في عالمنا العربي تأخر الإصلاح عدة قرون، وشهد بداياته الفعلية مع الشيخ محمد عبده في منتصف القرن التاسع عشر، ووصل لذروته في العصر الذهبي للثقافة العربية مع اسماء مثل طه حسين وأحمد أمين وعلي عبد الرازق؛ ولكن على عكس التوقعات، سرعان ما وقعت الانتكاسات على جميع الأصعدة، فلم يؤدِ هذا الإصلاح إلى التغيير المطلوب، سواء على مستوى التفكير الجماهيري أو حتى الحكومات، ورجعت الدعاوى الأصولية وترسخت سلطة رجال الدين أقوى مما كانت عليه. من هذا المدخل يمكن قراءة كتاب أحمد أمين على أنه محاولة لإنعاش هذا الإصلاح، بل ونقده في كثير مما توصل إليه، والإضافة عليه في محاولة لوضع أسس قد تساعدنا على المضي قدمًا، على الأقل كأفراد.
يعيب الكاتب في مقالاته الأولى تأثر المصلحين الأوائل المفرط بالحضارة الغربية، مما جعلهم ينظرون إلى تراثهم بنظرة النقص والدونية؛ وبالتالي، جاء إصلاحهم أشبه بالترقيع، يحاول أن يقول ما قاله المفكرون الغربيون، ولكن بلسان عربي، مهملًا جزءًا كبيرًا من التراث العربي والإسلامي، ومفرغاً لمضامينه مقابل الإعلاء من القيم الغربية. وقد أدى هذا الانفتاح غير المدروس إلى أزمة خلقية ومعرفية؛ فقد استوردنا ثقافة الاستهلاك وأسلوب الحياة مقابل خواء فكري وروحي. يستمر الكاتب بنقده فيعقد مقارنة بين كتب السيرة الأوائل والمعاصرين؛ فبينما ركز القدماء على الدقة والأمانة في النقل دون حرج، بكل ما تحمله من أمور قد تكون غير متقبلة أو مناسبة للعصر، لكن من المهم معرفتها لفهم سياقات وأحوال ذلك العصر، ركزت كتاب السيرة الأحدث على فكرة الانتقائية، بل واختلاق الأحداث، في محاولة لخلق رسول معاصر يحمل صفات عصرنا، مع إزالة كل الصفات البشرية عنه، ووضعه في مصاف الآلهة والتقديس المبالغ فيه، وهو ما كان النبي نفسه يخشى منه ويشدد عليه أصحابه.
يُقَسمُ أحمد أمين رؤيته للإصلاح إلى قسمين؛ الأول يتمثل في تنقيح التراث، وبالأخص السنة النبوية التي تأثرتْ جراء الصراعات السياسية والمذهبية، فيشرح آلية كتابة الحديث، ويبين مدى سهولة تلفيق الأسانيد، وبالتالي يرى أن الحكم على صحة الحديث لا يكون إلا بتقييم متنه ووضعه في سياقه الزمني؛ وعندها نرى أن العديد من الأحاديث وضعتها فرق لتمدح وتعلي من شأنها الخاص أو لتحط من قدر خصومها، أو لتتنبأ بالمستقبل وتروي قصصًا وأخبارًا من الماضي، وهي التي كان القصاصون يختلقونها لما تثيره من حماسة وعواطف لدى مستمعيهم، أو ما كان يمارسه فقهاء السلطان لتبرير أفعال الخليفة عبر الأحاديث. أما القسم الثاني فيتمثل في التمسك بروح الشريعة وما تحمله من أخلاق وقيم بدل الانشغال بالأمور الشكلية والتشريعات المرتبطة بزمان وعصر محددين.
التصوف: من الزهد إلى الدجل… كيف تحوّل المشروع الروحي إلى سوقٍ للخرافة؟
يخصص الكاتب جزءًا كبيرًا من كتابه لدراسة تاريخ التصوف في الإسلام، معترفًا بأن هذه الظاهرة لم تكن موجودة في صدر الإسلام، بل نشأت نتيجة أمرين: أولها، اتساع رقعة الدولة الإسلامية مما جعلها تختلط بثقافات وديانات الشعوب الأخرى، وعلى رأسها المسيحية التي تأثّر بها المسلمون بالأخص في حياة الرهبنة؛ وثانيًا، انتشار حياة اللهو والترف التي رسمت ملامح العصر الأموي والعباسي وإنغماس الناس في الشهوات وحب الدنيا. و يقسم تطور الحركة الصوفية إلى ثلاث مراحل: الأولى ظهرت في القرن الثاني الهجري ولم تنتشر على نطاق واسع، إذ ركّز دعاة تلك المرحلة على العودة إلى الأصل القرآني وعلاقة العبد بربه، مع تفضيل حياة الزهد والتقشف دون اعتزال الناس، وظلت محافظة على الطقوس والشعائر الإسلامية؛ ومع دخول القرن الثالث وتطور الحركة، نشأت نظرية معقدة حول علاقة العبد بربه والعشق الإلهي، حيث تخلّى المتصوفة عن الجانب الطقوسي واستبدلوه بطقوس مثل الرقص والغناء، مدعين بذلك قربهم من الله أكثر؛ ووصل الحال إلى تقديس شيوخهم ووضعهم في مرتبة تتعدى الأنبياء، لأن الله يخطابهم مباشرة. وقد أدى ذلك في النهاية إلى أن هيج الفقهاء عليهم، الذين بدأوا بشن حملات ضدهم وتكفيرهم وقتل عدد كبير منهم، وعلى رأسهم الحلاج. أما الطور الثاني فيعتبره الكاتب ثمرة لجهود الإمام أبو حامد الغزالي، الذي استطاع أن ينتقي من التصوف أفضل ما فيه، ويأصله فقهيا، ووضع منهاجه في كتابه الشهير “إحياء علوم الدين”، حيث تقوم رؤيته على الإعلاء من شأن المعرفة والحكمة الإلهية مع تنقيحها من العقائد الفاسدة مثل العرفان والحلول، وجعلها في خط متوازي مع العبادات والشعائر؛ وقد ساعد هذا الدمج على تقبل واستحسان كبير للقيم الصوفية والاتفاق على مبادئها وأهدافها. هذا الوضوح قاد إلى الطور الأخير، وهو عندما تحول التصوف إلى حالة جماعية، وأنشئت الطرق الصوفية وانتشرت في العالم الإسلامي، وأصبح لكل جماعة شيخ طريقة، مضفين عليه صفات الكمال والقدسية. وقد ركزت على حلقات الذكر الجماعية التي تُنشد فيها الأشعار والأغاني التي تمدح الإله