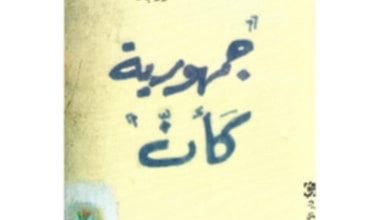مرّتّ الكتابة الشعرية بمنعرجات وتحولات، وتباينتْ حولها الآراء على مستوى التزامن والتعاقب، حاول القُراء تقييد الإبداع الشعري من خلال الرصد والتعميم، لكن الشعر ظل يُراوغ ويخاتل كلما اكتُشف أمره، يصنع لغة تخترق المألوف، في سعي حثيث لاستجلاب معنى نسبي، أو غيابه، تفنن الشعراء في تفردهم منذ العصر الجاهلي، واختطّوا أساليب تميزهم عن غيرهم، ولا تتطابق النصوص بأي حال.
سعتْ مرحلة الحداثة إلى النظر في النَّص الأدبي على أنه جسد مُكْتفٍ بذاته لا تربطه علاقة بسياقات نتاجه، واستنبطتْ خصائص جامعة تندرج تحتها الأنماط النّصية، لكن مرحلة ما بعد الحداثة لم تكتفِ بالمقاربة البنيوية، وفتحت النَّص على آفاق سابقة ولاحقة، لتجعل من المقاربة الأنطولوجية وسيلة للكشف عن المزيد من الدقائق دون قيد يحدّ من القراءة، وقد تعرّض هذا التوجه إلى الانتقاد؛ لما فيه من فوضى وغياب للتأطير والإجراء، ولعله ما من شيء تحت الشمس يخلو من الأطر، وأن غياب المنهجية أضحتّ بذاتها منهجًا، عوضًا عن أن الممارسات النقدية تحت هذه المقاربات، منهج يُضمر طرقًا إجرائية، وتوجهات تحليلية.
لم تُبدع الألفية جنسًا أدبيًّا مستقلًّا، بل عملتْ على تحوير الأشكال السابقة؛ لأن التجربة الشعرية لا تختمر على عجل، وتظل تتجاذبها الأقلام قرابة النصف قرن لتنضج وتُتجاوز.
وأبرز ما يمكن ملاحظته في الكتابة الشعرية في مرحلة الألفية هو (الاختلاف) سيما وأن قصيدة النثر شهدت زخمًا إنتاجيًّا، واعترافًا نقديًّا، وتداخلت فيها التجارب بين الأصالة والامتزاج بالأجناس الأدبية الأخرى مثل السرد، وتعميق اللحظة، وتداخل الأصوات، والنص المشهدي، والأشكال الموزونة ، والنص السريالي، والصوفي، والومضة، واتكأت بشكل كبير على الوسيط الرقمي، مما أدى إلى ظهور النص الرقمي والتشعبي، والتحول المستمر ما بين الرقمية والنصية، وربما يكون السياق العام عنصرًا مهما في إنتاج هذا النوع من النصوص، لأن المتلقي والمبدع في بحث دائم عن التحديث، كذلك التغيرات الكبرى في البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تطلّبت مرحلة أدبية مختلفة عن المرحلة الكلاسيكية.
)دون ذكر أسماك( لمحمد عبدالله
يتميز نصه بالمفاجأة، وكل عناصر النص تخدم الفكرة، ويعرضها في قالب ساخر ينتهي بخاتمة تكسر أفق التلقي، وإن كان القارئ الذي اعتاد أسلوب محمد عبدالله، يظل في ترقب )الديوان ص124_ 125(:
«أثر القصيدة»
لم يبقَ مني
سوى ما أنزفه الآن
لم يبقَ مني
سوى ذاكرتي الغائبة عن الوعي وعني
لم يبقَ مني
سوى فتات حب وقبلة واحدة في اليوم
لم يبقَ مني
سوى صدى خوفي من امرأة
بكتْ نيابة عن قبيلة في أقصى الحزن
لم يبقَ مني
سوى كلمة شكرًا ومعذرة ووداعًا،
لم يبق مني
سوى وشوشة أمي لي
والأثر الذي سببته هذه القصيدة.
)أثر القصيدة( في منجز غفل من التجني
س تحت تسمية )نصوص(، يُحاول كُتّاب هذا الجيل الكتابة وحسب غير آبهين بالجنس الأدبي، لكن القصيدة مكانها ديوان شعري، وهل اختلفت القصيدة لدرجة أن تُوجد خارج الديوان؟! وهل تراجعت قيمة التصنيف لِيُخفى في آخر صفحة بعد أن كان في الصدارة؟! ويظهر ذلك من خلال عبارة )من نصوص الديوان( المكتوبة بخط أحمر بشكل طولي في أعلى اليمين من الصفحة الأخيرة.الكلمة المفتاح في هذا الأثر الأدبي هي «الحزن»؛ حيث كررتها النصوص بشكل لا فت، لا يكاد يخلو نص منها، بصيغها المختلفة، رغم ما في النصوص من تجسيد ساخر، إلا أن هذه السخرية الظاهرة تُنبِئُ عن حزن عظيم يطقطق في مفاصل النص، واللغة بسيطة في مجملها، تنحو إلى التوظيف العكسي، والتنافر، كما يظهر من العنوان (دون ذكر أسماك)، هذا التحوير البسيط في القول المأثور (دون ذكر أسماء)، تم الاشتغال عليه من خلال استعارة صفة التدخين في لوحة الغلاف، ففي الخلفية البرتقالية المائلة للصُّفرة صورة فوتوغرافية لسمكة تدخن، خرجت من المياه لتتنفس الأكسجين وتتجول في الصحراء وتدخن!، وتم تدعيم هذه الصورة بنص على اللوحة الأخيرة للكتاب:
أقول لسمكة في حوضها الصغير لا أنوي صيدكِ
أردتُ فقط مشاهدة عالمكِ الشفاف
قالت:
وأنا لا أنوي إغراءك
أردت فقط تحسين مزاجك ولعلي أذكِّرك
بشيء لا يُذكرك بشيء
أو بموعد تأجل على حين كذبة،،
قلتُ:
تأخرتُ عن حزني سأذهب،،
وسلام عليك في حوضك الصغير
وسلام علينا في حوضنا الكبير.
في هذا النص يتخذ الشاعر من حالة السمكة معادلًا موضوعيًّا للعالم الذي يحيا فيه، يسرد بتدرج عالمها الشفيف وشعوره تجاهها، وترد لتنقل النص من الشمولية إلى المضارعة بين الرجل والمرأة، (لا أنوي إغراءك) ردا على قوله (لا أنوي صيدك)، (لعلي أذكرك بشيء لا يذكرك بشيء)، لحظة التأمل التي تفضي إلى العدم، ويستوي فيها التذكر والنسيان، الشيء واللاشيء، الحوض الصغير/الحوض الكبير، في مفارقة لتجد الذات نفسها داخل حوض كبير! بينما كانت تنظر إلى الحوض الصغير من عليائها وتتمتع بسلطة مطلقة.
ومن المحطات اللافته في المناص؛ الخطاب الذي يوجهه للقارئ بين الفينة والأخرى في اللوحات، تحت عنوان )استراحة قاريء( «عزيزي القارئ يمكنكَ أن تستريح هنا لبعض الوقت، الديوان ص35»، «عزيزي القارئ الطيب لا تتسرع في الحكم على ما سبق وخذ نفسًا عميقًا ثم تابع القراءة، الديوان ص 101»، «عزيزي القارئ منذ الآن لم تعد عزيزي فلتذهب إلى الجحيم، الديوان ص 145»، هذه التوظيفات تحتاج قراءة تداولية، لدراسة مستويات الخطاب وتأويلاته؛ حيث ينفتح النص على عوالم تلقّيه، بعد انفتاحه على عوالم كتابته، ففي هذه الاقتباسات تدعيم للقضية الكبرى التي تُعبر عن قلق الكتابة وقلق الجيل وهواجسه في كيفية استيعابه ورأي القارئ في تلقي ما يكتب، والضيق بكل ذلك والمضي دون اكتراث.
ومن الخصائص التي تميز بها أدب محمد عبدالله، صناعة بعض نصوصه في عمل فنيّ بخلفية صوتية وبصرية، وغير ذلك من المعالجات الرقمية، التي تعدل مجرى التلقي وقد تغيره، بالإضافة إلى نشاطه عبر وسائل التواصل، مما يجعل نصه تفاعليًا، يُشارك القارئ في إنتاجه.