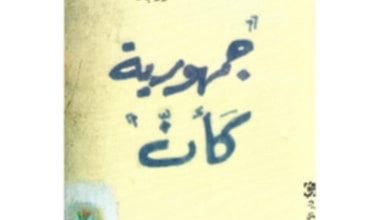** يوجد سيف رمال آخر أكثر صعوبة سيواجهُنا، الا وهو (سيف البرليه) على الطريق المهجور (العوينات – دنقله) الشمالي الأخطر من بقية الطرق، الذي يحاذي موازياً الحدود المصرية من جهة الجنوب، وسمي بسيف البرليه لوجود سيارة برليه صفراء اللون مثل التي نركبها نحن الآن، وقد تعطلتْ منذ سنين وعندما يئس ركابُها من مجيء أي منقذ لهم بادروا بالانتشار على الأرض المجاورة في كل الاتجاهات بحثاً عن مورد ماء، في محاولة أخيرة لإنقاذ انفسهم من الموت اللَّائح.. بعض النسوة والأطفال لعدم قدرتهن على احتمال المشي في الحر وتحت الشمس الحارقة رفضن المخاطرة وآثرن البقاء تحت ظل الشاحنة، وأي مورد للمياه في هذه المناطق شبه معدوم، فلا آبار مياه واضحة في القريب، وأقرب بئر ماء يوجد قبل مدينة (دنقله) على نهر النيل بمائة كيلومتر تقريباً، وعند بلوغه يتم للمسافرين الاستحمام وغسل ملابسهم بوسعة وروية، انتظروا ولم تمر بهم شاحنة أخرى أو سيارة صغيرة لتقدم لهم العون وتنقذهم من هذا الموت المحقق، حتى نفذ ماؤهم كليةً، وعندما لحقتْ بهم شاحنة لم يجدوا أي من ركابها على قيد الحياة، سوى طفل سوداني لا يزال يرضع ما تبقى من حليب في ثدي أمه المتوفاة حديثاً، ومن شبه المؤكد أن لا حليب في تدي الام، فتناولوه من صدرها وأسعفوه وتكفلوا بالعناية به ليُكْتب له العيش من جديد، واليوم لازالتْ تلك الشاحنة تطمرها الرمال، ولا يظهر منها فقط الا سقف قمرة القيادة بلونها الاصفر تلوح للمارين وشاهدة على قساوة الصحراء. مجموعة أخرى من الركاب الرجال وجدوا أنفسهم في مأزق صعب للغاية يهدد حياتهم لو بقوا على حالهم هذا من الانتظار، فبادروا بالمغامرة الى المجهول لكنهم اختلفوا فيما بينهم على تحديد الطريق الصحيح الذي يجب ان يسلكوه، حتى يصلوا اعتماداً على الحظ فقط الى أقرب بئر ماء يتوقعون وجوده ، وكل واحدٍ منهم – أحدهم شخص ليبي – ركب رأسه وتمسك برأيه في الأمر وذهب لملاقاة مصيره على حده, انها غريزة البقاء فكيف يسلم الانسان نفسه الى رأي مشكوك في صحته ؟، في هذه اللحظة اعتبرَ ما حدثَ له من سوء حظه, لكنه لم يفقد الأمل نهائياً، كان يمشي خائفاً ويبكي ويلهج مكرراً في صورة ضراعة ودعاء:- أعيديني سالماً الى اهلي ايتها الصحراء الخائنة, خففي من قسوة عطشك عليّ وعلى رفاقٍ أعزاء تشردوا بفعل بطشك, وارحمي قلوب أمهات تنفطر الآن وهن ينتظرن عودة ابنائهن بفارغ الصبر. ومن شدة عطشه أخذ يبحث عن الاحجار الصلبة المسطحة الملساء من حوله، ويتأكد من احتفاظها ببقية من برودة الليل ويضعها لصيقة بجانب شدقيه ليلتمس منها شيئاً من البرودة، ويحس معه وفق ما يتهيأ له وكأنما شرب جُرعة ماء.. ثم أصبح حقيقة يعيش معركة مع الوقت ويشعر بملابسه ثقيلة على ظهره وهو يمشي ويقترب من موته أكثر، وبدأت ترهقه وكأنها تزن قنطاراً، ففكر في التخلص منها ورميها جانباً والبقاء عارياً، لعل هذا يخفف من آلام عطشه ومخاوفه المتزايدة، لكنه أدرك في اللحظة الأخيرة انه على خطأ مما يفعل، بعد تذكره لكلمات ابيه عندما كان يحصد الزرع في وادي سوف الجين أواخر فصل الربيع والجو حار، وهو يرتدي معطفاً شتوياً ثقيلاً، كان هذا منذ عقود مضتْ وكان الجميع يسألونه في استغراب واستنكار:- اسطى سالم ترتدي معطفاً ثقيلاً وتضع عمامة كثيفة على رأسك، وانت تحصد الزرع تحت أشعة الشمس، كيف يكون هذا؟ أمرك عجيب! ألا تحس بشدة الحر؟ فيجيبهم بكل بساطة :- ما يقي من لباس في فصل الشتاء من البرد، يقي أيضاً من الحر في الصيف. ويضيف مؤكداً أنا الآن اشعر بجسدي مكيفاً تماماً، وأنعم بالبرودة في الداخل، رددوا عليه :- لم نسمع بهذه الفكرة من قبل! هذا اكتشافك لوحدك. تخلى (الليبي) عن فكرة خلع ثيابه والتخلص منها، وتمسك بفكرة أبيه في السابق وأبقاها على جسده، ويكون قد أمضى مدة يومين في توهانه، توقف مرات عديدة كي يلتقط انفاسه ويستأنف المشي من جديد, من حسن حظه اهتدى عن طريق الصدفة وحدها الى مورد ماء في اللحظات التي كاد ان يقع فيها على وجهه ويموت ظمآناً, ظاناً انه تمكن من النجاة بنفسه من الموت المحقق, وصل الى البئر ووقف على فوهته فرحاً, تطلع حوله فلم يجد دلواً ولا حبلاً, استطلع باحثاّ في الارجاء القريبة حول البئر، فلم يعثر على حبل ولا على دلو، ولم يعرف طريقة للوصول بها الى الماء، بعد فشله ازداد شعوره بالخوف والعطش، تخيّل في لمحة بوضوح اثنين من رفاقه قد لفظا روحيهما أمام عينيه ما بينهما حوالى ثلاثة ساعات فقط، تركهما و استأنف المسير في انتظار ميتته هو الآخر، اقترب من البئر ونظر الى قاعه، ورأى دائرة الضوء بها صورة السماء الزرقاء مرسومة كالقمر العائم على سطح الماء الساكن، تتوسطها صورة وجهه, يرى الماء بكل العطش دون القدرة على الوصول اليه, صورة وجهه مغمور في الماء، يخرج لسانه ويحركه ملوّحاً به لكن لسانه لا يستطيع الوصول الى الماء كي يلعق ما يطفئ ظمأه ولو ببلة, ماذا عليه ان يفعل في هذه اللحظة الثمينة والحرجة، حتى يصل الماء البعيد بعمق أكثر من عشرة أذرع, ترى الماء أمامك وصورتك واضحة على صفحته، ولا تستطيع الوصول اليه. استبعد فكرة أن يلقي بنفسه في البئر من هذا العلو المميت، وعليه في نفس الوقت ان يصل عاجلاً الى الماء، والا ستضعف قواه أكثر وتخور بعد لحظات، ويفقد القدرة على الحراك والتفكير في فعل أي شيء, ومن بعدها ربما يموت.. المكانُ في صمت مطبق ومازال لم يصل الماء بعد، وداهمته فكرة أن يسمع صوت الماء علّه يمنحه شيئاً من الاطمئنان، ويشعره بالارتواء الوهمي, وأيضاً كي ينتقم منه مادام لم يستطع الوصول اليه, فألقى بعدة أحجار صماء صغيرة, فأتاه صدى بقبقة ارتطام الحجر بسطح الماء, وكرر ذلك عدة مرات كي يزداد استئناسه بصوت معشوقه البعيد القريب، وتخيلُ طعم الماء, وداهمه الخوف من تضييع الوقت وهو في آخر رمق, الى أن طرأت عليه فكرة أخرى في آخر لحظة تحت الحاح الظمأ، قد تنجح معه وقد تفشل, اذ قرر ان ينفّذ ما اهتدى اليه بأن يمزق ثوبه – الذي كاد أن يلقي به في البر ويتخلص منه منذ ساعات – الى شرائط كثيرة، على شكل خيوط ويربط بعضها ببعض ليصنع منها حبلاً طويلاً, حتى يصل الى الماء, وبما أنه ليس لديه دلواً، فلف كرة صغيرة من بقية قماش ثوبه وربطها بإحكام في احدى طرفي الحبل، وأثقلها بحجر صغير كي تغطس في الماء وتتشرّب به الى أقصى حد ولا تبقى طافية, ثم أدلى بها في البئر حتى لامستْ كرةُ القماش قاع البئر، وغطستْ في الماء وامتصتْ كمية من الماء, وأخرجها من البئر وهي تقطر بسرعة، حتى لا تفقد جزءً كبيراً مما امتصتْ من ماء, وبقي الكثيرُ من الماء بين طيات الكرة, وأخذ يعصرها في فمه، ويكرر العملية حتى ارتوى تماماً, وملأ مطرته (زَّمزميَّته) بنفس الطريقة البطيئة، بعد احضارها اذ كان قد طوّح بها في غمرة شرقه منذ قليل في مكان قريب, وبقي ينتظر. بعدها بأيام قليلة عثرتْ عليه احدى القوافل التي اعتادتْ ان تردَ الى هذا المورد، فأطعموه واسعفوه واصطحبوه معهم الى ديارهم، بعد ان استفسروا منه عن نسبه واسمه ثم أعادوه الى اهله سالماً، وهم تجار ليبيين في أسواق مدينة دُنقله.. ينعتونه اليوم بعد هذه الحادثة بالميت, اذ أنه قد نجا بأعجوبة من موتٍ مؤكد. منذ هذه المغامرة التي سيّرته فيها الأقدار، ونال فيها وحده جائزة النجاة بالحظ دون بقية رفاقه، الذين قد أصابهم جميعاً الهلع والاحباط المطلق، مما ضاعفا من شعورهم بالعطش حتى ماتوا وفارقوا الحياة عطشاً، عند عودته برفقة هؤلاء الناس الجدد عثروا في الطريق على جثة أحد الرفاق وكانت رائحته نتنة وحفروا له قبراً وتم لهم دفنه فيه بعد تأدية صلاة الجنازة عليه، ولكن كثيراً ما لا تتحلل جيفة الحيوان النافق بسهولة لعدم وجود كمية كافية من المياه بها وهي في أغلب الأحيان تموت عطشاً وتبقى سوداء مثل القديد المجفف كالمحنطة، كذلك الناس الذين تاهوا في الصحراء عند موتهم بسبب العطش لا تتحلل جثثهم بل تبقى شبيهة بالمومياء بنية أو سوداء اللون.. ورغم كل ما حدثَ له ولكي لا يعيش تجربة العطش مرة أخرى، ويكابد آلامها في مواقف أخرى ، لم يمتنع عن الترحال في الصحراء ويقطع صلته بها لأنها أبانت له عن وجهها العابس مرة واحدة, بل واصل تمسكه بها واستمرتْ سفرياته في ربوعها بكل تحدي, وكأن لم يطرأ له شيء، لكنه ازداد خبرة وحذراً حاول تدريب نفسه على تحمل العطش ومقاومته، وأيضاً التعرّف على مواقع المزيد من الآبار غير المعروفة لديه سابقاً في هذه الصحراء، وكثف من المامه بجميع موارد المياه, ومواقعها وقدّر المسافات فيما بينها، واصبحَ شغلُه الشاغل الحديثَ والاستفسار عن هذه المناهل والآبار وما يتعلق بها من معلومات، حتى أضحتْ واضحة في ذاكرته، كما تعلّم من هذه التجربة المريرة أشياء أخرى كثيرة، فقدّر المدة التي يستطيع تحملها الانسان العطشان بدون ماء، سواء في فصل الصيف أم في الشتاء.. وكم من مرة بعد ذلك بقي الليبي والصحراء فقط وجهاً لوجه، تلوّح له بالعطش و يواجهها بالصبر والتحمّل، ويخرج منها منتصراً، لذلك بعد وقوع العديد من الأرواح ضحايا للعطش نجد أن الكثير من الناس قد تعارفوا على فعل الخير وتواصوا به، وتنافسوا تطوعاً على حفر العديد من آبار الماء في الصحارى ويتركونها لتشرب منها الكائنات الظمأى وأسموها منابع الحياة، واصبحتْ أماكن عديدة في الصحراء الليبية تعرف بأسماء الآبار التي حفرت بها، وهي لا تحصى،
وقد بلغ عدد المعروف منها أكثر من ثلاثين بئراً مثل بئر غنم وبئر علاق وبئر العطشان وبئر السارّه وبئر دريدر… الخ، والى اليوم يمكننا معرفة مواقع الآبار لكن لا يمكننا معرفة كل أسماء من ساهموا في حفرها